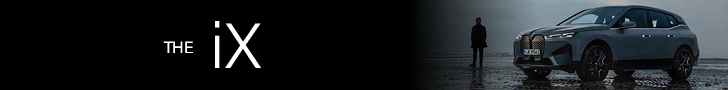إلى “أطفال العتمة”.. سامحوني!

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
سيد إسماعيل
جاءني صوتها أخيراً، بعد أكثر من أربعة أشهر من الانقطاع، عابراً أميالاً من العذابات وروائح الدم والبارود، والأجساد التي اقتاتت عليها الكلاب والقطط لشهور، وجثث البيوت الإسمنتية التي تراكمت فوق بعضها في كل مكان، وسط خذلان ذوي القربى والإنسانية بأسرها: يومها مضى على اندلاع الحرب على غزة أكثر من مائة وعشرين يوماً. كانت المرة الأولى التي أسمع فيها صوت أختي، من خلال ربط هاتفها بشبكة “واي فاي”، في المدرسة التي نزحت إليها هي وزوجها وأطفالهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والأربع سنوات.
شمال قطاع غزة، حيثُ يقيمون الآن، قد أخذ نصيبه الأكثر قسوة من مأساتنا الفلسطينية الحالية. سألتها عن أسعار المواد الغذائية، فأجابتني: “أسعارها عندنا متذبذبة من يوم لآخر، وأحياناً في اليوم ذاته، لكنها عموماً غالية بشكل لا يمكنك تخيله. كيلو الدقيق بـ120 شيكل (حوالي 30 يورو). كيلو العدس المجروش 70 شيكل (حوالي 18 يورو). الخضروات مثل البصل غالية جداً، ويبلغ سعره 50 شيكل (حوالي 14 يورو).. “. واصلتْ هي سرد قائمة السلع الغذائية وأسعارها الصادمة، وأنا عاجز عن التعقيب على كلامها. المشكلة أن أهل قطاع غزة لا يستطيعون شراء هذه السلع بتلك الأسعار بتاتاً. زوج أختي مثلاً مهندس عاطل عن العمل منذ بداية الحرب، وبالطبع لم يتلق أي راتب أو مبالغ مالية، مثل معظم الموظفين في قطاع غزة، إضافة غلى أن بيته قد تعرض للتدمير، مثل 85% من منازل غزة. بحسبة بسيطة وجدتُ أن أسرتهم بحاجة إلى ما يقرب من 800 يورو شهرياً على الأقل للإيفاء بأبسط احتياجاتهم، وأن يبقوا أحياء، ما لم تشطبهم قذيفة أو رصاصة إسرائيلية من سجل الأحياء.
كانتْ تصلنا أنباء مروعة عن المجاعة التي يتعرض لها أهل قطاع غزة هناك، في ظل غلاء الأسعار وشح السلع، وأن هنالك من مات بالفعل بسبب الجفاف والجوع، وهو أمر لم نسمع به أبداً من قبل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بعدها، بدأتْ تصلنا صور مروعةٌ لضحايا المجاعة بغزة، فيما كانتْ آلاف الشاحنات المتخمة بالمساعدات الإنسانية تنتظر دورها في الدخول إلى قطاع غزة، في ظل تعمد إسرائيلي واضح للجميع لإبطاء دخول تلك المساعدات. كانتْ وسيلة قتل جديدة لا تختلف عن وسائل القتل الممنهج الأخرى، لكنها أكثر إيلاماً بكثير: من سيموت بالقصف الصاروخي، سيموت ميتتة سريعة، لكن من سيتم تجويعهم حتى الموت سيتمنون الموت ألف مرة كل يوم، وهم يرون أطفالهم يموتون أمامهم.
“ما العمل؟؟ كيف يمكنني مساعدتهم؟؟” ظل هذا السؤال يؤرقني. كنتُ أبحثُ عن وسيلة لمساندتهم بأي طريقة. حتى لو أرسلتُ لهم مائة يورو. هو مبلغ ضئيل للغاية، لكنه المتاح بالنسبة لشخص لا يعمل مثلي. سألتُ أكثر من شخص، حتى لو تمت التحويلات بشكلٍ غير مباشر، لكن الجواب كان واحداً: هذا مستحيل. إيصال الأموال إلى قطاع غزة أمر صعب للغاية. الأبواب موصدة في وجهي، وصوتُ أختي وأطفالها لا يفارقني، والتجويع مستمر دون توقف.
هؤلاء النازحون الذين يواجهون خطر الموت جوعاً كل يوم لا تتقوف المجازر ضدهم. يرافقهم الموت كل يوم ويأخذ فريسته منهم بمختلف ذخائر الحرب: بالصواريخ وقذائف الدبابات والمدفعية والرصاص بأنواعه. قابلتُ أحد الفلسطينيين في أحد المحلات التجارية بمدينة “أنتويرب” البلجيكية. أنا لا أعرفهُ من قبل وهو لا يعرفني. لكن موضوع الحرب الذي تم النقاش فيه، جعلني أسأله عن مكان عائلته، لأجد أن زوجته وأولاده بنفس المدرسة التي نزحت إليها أختي وزوجها وأولادها. كانتْ صدفة غريبة!
قال لي: “أنا لم أر زوجتي وأبنائي منذ عامين ونصف. وصلتني رسالة من غزة تقول بأن ابني “أنس” قد تم قتله في المدرسة، في مجزرة ارتكتبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك. لحظة من فضلك..”. أخرج هاتفه المحمول، ليريني صورة طفل أبيض البشرة، نحيل القوام، مغمض العينين، وقد احتواه كفن صبغ بياضه لون الدم: “كان عُمْر ابني اثنتي عشرة سنة فقط. بقيتُ بعدها في حالة اكتئاب لثلاثة أشهر، لم أخرج خلالها من بيتي إلا للضرورة. هذه صورتي قبل استشهاد ابني وبعدها. هل تستطيع ملاحظة الفرق؟؟ “.
تأملتُ صورته الشخصية قبل الحرب على غزة، التي ظهرت على شاشة هاتفه المحمول، ووجهه هو. يا إلهي! لقد كبر هذا الرجل عشر سنوات على الأقل في غضون أشهر! لقد كان هذا الرجل مثالاً حياً للألم المجسد السائر على قدمين. قال لي الرجل بنبرة فرحٍ غريبة لم أنسها أبداً: “ابني الشهيد محظوظ والحمد لله! إذ أننا تمكنا من دفنه في قبر له وحده!! “. أدركتُ السبب لاحقاً: في هذه الأيام، أصبحتْ معرفة هوية صاحب الجثة، وأن يدفن بطريقة لائقة، في مكانٍ معلوم يخصه فقط، حظاً عظيماً! حتى كتابة هذه السطور، مجهولو الجثث والمصير صاروا بالآلاف، ضمن أربعين ألفاً، ما بين شهيد ومفقود، ثلاثة عشر ألفاً منهم من الأطفال الذين لن يكبروا أبداً.
عدتُ إلى بيتي، لأجد “فيسبوك” يقترح علي صديقاً جديداً. لقد كان هو! دخلتُ إلى حسابه الشخصي، لأرى ضمن منشوراته هناك وجه ابنه “أنس” واضحاً، بملامحه الطفولية، وشعره البني الفاتح، وبشرته الناصعة، وعينيه الخضراوين، مع كلمات النعي المعتادة. ثلاثة عشر ألف طفل، أغلبهم لم يكونوا محظوظين، وكثير منهم قتلوا أشلاء لم يتمكن أحد من التعرف عليها، أو تركت جثثهم في العراء كي تتغذى عليها الكلاب والقطط الضالة، أو دفنتْ بشكلٍ جماعي، محتضنة جثث أهلها، أو تُرِكَتْ كي تتعفن تحت ركام منازلهم. وهنالك مليون طفل آخرون، ينتظرون المصير ذاته، ويموتون ببطء، بفعل الجوع والبرد ونقص الأدوية والرعاية الصحية.
منذ بداية الحرب على غزة، قل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو” إن الحرب هي حرب بين “أبناء النور وأبناء الظلام”، جاعلاً من مليون طفلٍ فلسطيني هدفاً للقتل المباشر والتجويع وتحويلهم إلى “أبناء للعتمة”، بلا مدارس ولا عيادات صحية ولا جامعات ولا مستقبل، وسبعة عشر ألفاً منهم أصبحوا أيتاماً، والآلاف منهم معاقين. عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا، خلال خمسة أشهر تقريباً من الحرب على غزة، يساوي عدد جميع الأطفال القتلى في جميع أنحاء العالم، خلال جميع الصراعات والحروب، على مدى السنوات الأربع السابقة، بحسب شهادة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “فيليب لازاريني”.
كنتُ أتابع حساب سيدة إسرائيلية، من الداعين للسلام وإنهاء الحرب على غزة، نشرتْ صورة طفلٍ فلسطيني غزي، تحول إلى هيكل عظمي، بسبب المجاعة التي فرضها الاحتلال على أبناء قطاع غزة. صدمني تعليق لسيدة إسرائيلية أخرى، لا زلتُ أذكرُ تعليقها: “يتحمل ذنبه قادة حركة “حماس”، الذين تسببوا له ولغيره من المدنيين بهذه الحرب”!
كنتُ قد قابلتُ وزيرة بلجيكية، قبل أيام، في لقاء بعيد عن عدسات الإعلام، وذَكَرَتْ أن “حماس” قد أعطتْ الحجة للإسرائيليين أن يفعلوا ما فعلوه بالمدنيين الفلسطينيين. رددتُ على حجتها بالقول: ” لقد خرج من حي “مولنبيك” في “بروكسل” العديد من الإرهابيين والمتطرفين (منهم من قاموا بتفجيرات في “باريس”، و”بروكسل”). كم قصف قمتم به ضد حي “مولنبيك”؟؟ كم طفل وامرأة قتلتموهم في حربكم ضد هؤلاء الإرهابيين؟؟ كم منزل دمرتم؟؟ أياً كان الأمر، لا يمكن أبداً القبول باستهداف المدنيين..”.
في فيلم “الطنطورة”، الذي مولته إسرائيل بنفسها، يظهر رجلٌ عجوز، كان مقاتلاً عند حدوث النكبة عام 1948، أنكر حدوث المجازر وقتها ضد المدنيين الفلسطينيين، الذين كان من بينهم أطفال، قبل أن يُسْمِعَهُ الصحفي الذي أجرى المقابلة معه اعترافات أحد زملائه بنفس كتيبته العسكرية، وكيف قتل العديد من القرويين الأبرياء بطلقة في الرأس من مسدس “باربيليوم”. قال ساعتها مصدوماً: “هذا مثل ما فعله النازيون بنا بالضبط..! “. تلك الجملة التي قالها المقاتل السابق في العصابات الصهيونية لخصت كل شيء..
إلى أبناء شقيقتي “دعاء”: “عبد الله” (ثلاثة عشر عاماً)، و”نور” (إحدى عشرة سنة)، و”سارة” (سبع سنوات) و”سلمى” (أربع سنوات)، وإلى مليون طفلٍ آخر من قطاع غزة، هم بقية “أبناء العتمة” من الأطفال. أرجو أن تسامحونني. إنني عديم الفائدة لكم، طالما أنكم لا زلتم في نظر العالم جزءاً من “أبناء العتمة”، وتستحقون ما جرى لكم من مجازر وقتلٍ وتجويع وحرمان من أبسط حقوق الأطفال، فقط لأنكم من “غزة”!