– مارينا ميلاد:
نحو 25 كم جنوب درنة، ليبيا – وسط غبار أتربة يتصاعد تدريجيا ليملأ الجبل، يرتدي “جمعة” بدلة بيضاء يغطي بها جسمه بالكامل، ثم يضع الكمامة على وجهه، وينحني لوضع الجثث المكدسة أمامه في حفر عميقة أشبه بالخنادق، يحمل الواحد منها 30 جثة، منها معلومة الهوية ومنها مجهولة.
لقرابة أسبوعين، يفعل جمعة أبو جازية نفس الشئ متطوعًا.. ذلك بعدما فاحت رائحة الموت وتراكمت الجثث في كل أرجاء المدينة عقب الإعصار الذي ضربها.. فوصل عدد من دفنهم في منطقته فقط إلى 1010 (حتى الآن).
وفي ثلاث محافظات مصرية تبعد عن كل ذلك نحو ألف كم، كان الآثر ممتداً، حيث أسر مكلومة يزداد يأسها في العثور على أبنائها – أحياء كانوا أو أموات – مع هذا السيل من الجثث وكل عملية دفن يقوم بها “جمعة” وغيره في تلك المقابر الجماعية..
فلا يهدأ “أحمد” عن إجراء كل الاتصالات الممكنة للسؤال عن مصير ابن خاله، وفي نفس الوقت، تنهمك “سعاد” في إعداد فاكسات لوزارتي الهجرة والخارجية، وتتعشم أن تجد ردًا حول شقيقها.. أما “ياسر”، فاستسلم لفكرة موت ابنه ودفنه بهذه المقابر، وذهب لاستخراج شهادة وفاته.
هؤلاء ضمن أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين (وفقاً لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية)، بينهم 291 مصريًا تم الإبلاغ عن فقدهم رسميًا في مدينتي درنة وطبرق – حتى اللحظة، كما ذكرت سها الجندي (وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج).
صباح كل يوم، يقف “جمعة” (45 سنة) أعلى الجبل، منتظرًا قدوم الجثث من الأسفل أو من “الوادي” – كما يقولون. فهناك، تعمل فرق من الهلال الأحمر الليبي ومتطوعون على غسل وتكفين مئات الجثث وإرسالها له لدفنها.
تأتيه تلك الجثث وهي تحمل أرقامًا تميز معلوم الهوية عن المجهول.. وبناء عليها، يقسم أماكن دفنهم.. فيقول: “ندفن الجثث المعروفة مع بعضها بعد تسجيل أسمائها، والمجهولة نضعها في مكان أخر حتى إذا جاء أفراد الطب الشرعي لآخذ مسحة من الحمض النووي (DNA)”.
كان الوضع عشوائيًا في أول الأيام، كما يحكي “جمعة”، فالدفن يتم بسرعة ودون آخذ أي تدابير ولا عينات. لكن الوضع تغير قليلا بمرور الوقت، وزودهم الهلال الأحمر الليبي بالملابس والأدوات، وباتت الجهات المختصة تحصل على عينات من الجثث قبل قدومها إليه وتسجل بياناتها.
ولا إحصاء دقيقًا حتى الآن عن عدد ضحايا إعصار “دانيال”، إلا أن الأمم المتحدة تقدرهم بحوالي 11300 شخص. لكن ما يصفه “جمعة” يؤكد أن العدد مرشح للزيادة الكبيرة: “نظل ندفن منذ بداية النهار وحتى الثانية صباحًا حتى تنفد طاقتنا. فالجثث لا تتوقف.. وكل يوم ينتشلون جثامين من تحت الأنقاض ومن البحر”.
وبين هؤلاء الذين يدفنهم “جمعة” كل يوم، مصريين وسودانيين وسوريين، كما يذكر. فالمناطق التي ضربها الفيضان، معروفة بتمركز الأجانب لرخص إيجارها.
يتابع أحمد إبراهيم، الذي يبحث عن ابن خاله، تلك المعلومات والصور ومقاطع الفيديو الخارجة من درنة، والتي تكشف عن أرض قاحلة، مباني ابتلعها البحر، جثث لفظها، ومقابر جماعية تتوارى فيها إلى الآبد. فيقول: “كل الأشياء تدعونا أن نستعوض الله فيه، لكن لازالنا على أمل”.
فانقطعت كل أخبار أحمد صبحي (21 سنة)، والذي كان يعمل هناك في مجال تركيب السيراميك. ومنذ ذلك الوقت، يحاول أحمد إبراهيم أن يكون “همزة الوصل” بين أسرته الساكنة بمدينة الحامل في محافظة كفر الشيخ والموجودين في ليبيا. فيحكي أنه تواصل مع صاحب الحوش الذي كان يقيم به، وذكر له أن “الحوش نفسه اختفى تمامًا”. ولم يرجح الرجل أن يكون قريبه على قيد الحياة.
كما أنه وصل إلى أحد الضباط هناك، لكنه لم يجد أثرا له أيضًا، فأبلغه “إنه لو كان حيًا لظهر.. لكن الأحياء قليلون”. ثم وضع اسمه على قوائم المفقودين.
رغم كل ذلك، لايزال “أحمد” يبحث عن أي شيء يمكن أن يتشبث به، فيقول: “سمعت بوجود ناجين بنادي درنة أو فوق الجبل الأخضر.. وسمعت أيضًا أن هناك مصابين يجدونهم لكن لديهم حالة أشبه بهيستريا، فيمكن أن يكون بينهم”.

ويتمركز المصريون العاملون في ليبيا على هذا النحو: 200 ألف في الشرق (وهي المناطق المنكوبة)، و150 ألفًا في الغرب، ذلك وفقًا لقواعد بيانات وزارة الهجرة، أي الأعداد المسجلة رسميًا فقط. وتلقت وزارة الهجرة وحدها قرابة 400 اتصالا من أسر هؤلاء العاملين بعد أن فقدوا التواصل مع ذويهم، بحسب سها الجندي (وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج).
من خلال تلك الاتصالات والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول سعاد عادل الوصول لأي معلومة تخص شقيقها “عمرو” (35 عامًا)، الذي كان يعمل بأحد المحال الكهربائية.
المكالمة الأخيرة بين “عمرو” وزوجته وابنته جرت قبل ساعات من مهاجمة الإعصار للمدينة وانهيار سديها.. ومنذ طارت تلك الأخبار لأسرته بمركز بلقاس (محافظة الدقهلية)؛ حاولوا الوصول إليه بكل الطرق، حتى استطاعوا في النهاية التواصل مع أحد أصدقائه، والذي أخبرهم “أنهم خرجوا جميعًا فوق سطح أحد البنايات المرتفعة، لكن وبسبب شدة المياه، لم تصمد وانهارت، حينها تفرقت بهم السبل”.
تمنت “سعاد” لو لم تكن سمعت تلك الرواية وتخيلت ما حدث لأخيها. ويزيد من إحباطها الآن عمليات الدفن الجماعي التي تتم بوتيرة متسارعة على يد “جمعة” وأربعين متطوعًا في منطقة مرتوبة، ومثلهم في منطقة الظهر الأحمر غربًا.
لذا حثت منظمة الصحة العالمية، السلطات الليبية على عدم الإسراع في عمليات الدفن الجماعي، لما يسببه من اضطرابات نفسية طويلة الأمد لأفراد العائلات، ومشاكل اجتماعية وقانونية. ودعت إلى استخدام مقابر فردية موثقة بشكل جيد ويسهل تعقب مكان وجودها.
لكن في ليبيا ذات الأغلبية المسلمة، يحرص الناس على إسراع دفن الميت إكراما له. وأصدرت لهم دار الإفتاء الليبية، فتواها لتسهل عملية الدفن مع تدفق الجثث الحاصل الآن: “إذا نزل الأمر الفظيع وكثر الموتى جدا لابأس أن يقبروا بغير غسل إذا لم يوجد من يغسلهم. أما الأكفان قد تكون من القماش أو غيره، جديدا أو قديما، أبيض أو غير ذلك، ويجوز عند الضرورة أن يكفن عدد من الأموات في كفن واحد وأن يدفنوا في قبر واحد ولو كانوا رجالا ونساء”.

وعليه، كان قرار الدفن الجماعي أمرًا واقعًا بالنسبة لشخص مثل ياسر محمد، حيث دٌفن ابنه الأصغر “عماد” (18 سنة) بهذه الطريقة، وفقا لما ابلغه به أحد أقاربه هناك. بينما وصلت إليه جثة ابنه الأكبر “محمد” (23 سنة) ضمن 87 جثمان عاد إلى مصر بالتنسيق مع السلطات الليبية.
“ياسر” هو أحد أهالي قرية الشريف بمحافظة بني سويف، والتي فقدت وحدها 70 شخصًا على الأقل، كانوا يعملون في درنة. ووفقا لحديثه، “حين وقع الإعصار وجرف حوشهم، تعرف قريبه على جثة ابنه الأكبر، فيما ذكر له فيما بعد أن ابنه الثاني جثته لن تصلح للنقل، ودفنت في إحدى المقابر الجماعية”.
ويقول الأب، وهو يغالب دموعه، “لست متأكدًا من أي شيء، لا من موت ابني ولا من مكانه ولا من طريقة دفنه.. لكن ليس في يدي أي شيء لعمله!”.

وبعد أيام، أرسل له أحد أقاربه تصريحي الدفن من أحد مستشفيات طبرق دون طلب أوراق منه أو تحليل DNA.
وفي مستشفيات مدينة درنة، تمر أوراق مئات الجثث كل يوم. إذ يتفحص الأطباء كمًا هائلًا منها، وأغلبها “في حالة تعفن” بعد بقائها في البحر لأيام ووسط درجة حرارة تتجاوز الثلاثين.
لهذا يتحدثون عن أن أحد أكبر المشاكل التي تواجههم هي التعرف على هويات أصحاب الجثث. فيقول الدكتور محمد القويني (عضو غرفة عمليات وزارة الصحة الليبية)، في تصريحات له، “إن قسم الأدلة الجنائية التابع لوحدات البحث الجنائي حاول في البداية تصوير الجثث بغرض التعرف عليها لاحقا، لكن مع توافد كم هائل اضطروا إلى غض الطرف عن هذا الأمر”.
وتعاني المدينة الصغيرة ضعف إمكانيات مستشفياتها وتوافر أكياس نقل الجثامين والأدوات اللازمة، كذلك فرق التحليل الجيني. وتعلق سلطنة المسماري (عضو مجلس النواب بشرق ليبيا) لـ”مصراوي” على ذلك، قائلة: “الكارثة فوق قدرة ليبيا بأكملها وليس المدينة فقط، لذلك طلبنا مساعدة ومجيء فرق إغاثة من دول مختلفة”.

وبين شبكة طرق المدينة المنهارة والمسارات التي تتسع بالكاد لدخول سيارات الإغاثة، يمر جمعة أبو جازية بسيارته على “درنة” التي يطوقها الجيش ويمنع دخولها إلا بتصريح، وفقا لحديثه.. فيرى حجم الدمار الذي حل بها، يرى أكوام حطام، أشجار مقتلعة من الأرض، وسيارات تسبح في المياه الراكدة.
ومع تباطؤ حركة المرور ليصل إلى منطقة الدفن “مرتوبة”، يتذكر تلك السيدة المصرية التي جاءت إليه في الأيام الأولى للدفن ومعها جثث زوجها وابنيها بسيارة ربع نقل، ثم ذهبت لتبحث عن الثالث وتعود إليه.
فيقول: “لا أدرك حتى الآن ما شعور هذه السيدة ومن هم مثلها؟.. فالأمر كله مأساة بمعنى الكلمة”.
وبعد أن استغرق ضعف المدة، وصل “مرتوبة”، حيث تنبعث رائحة قوية من أماكن دفن الجثث لمرور الوقت. فبدأ “جمعة” ومن معه عَمل خرسانات فوق تلك الأماكن المبنيه من الطوب ومغطاة بالتراب.
لا يعرف أحمد إبراهيم أو سعاد عادل أو ياسر محمد ما إذا كان ذويهم تحت أيدي “جمعة” أم لا.. وفيما ذهب ياسر محمد لاستخراج شهادة وفاة لابنه بناء على تصريح الدفن، ترفض “سعاد” أن تفعل ذلك لشقيقها، وتتعلق بأمل يتلاشى كل يوم.
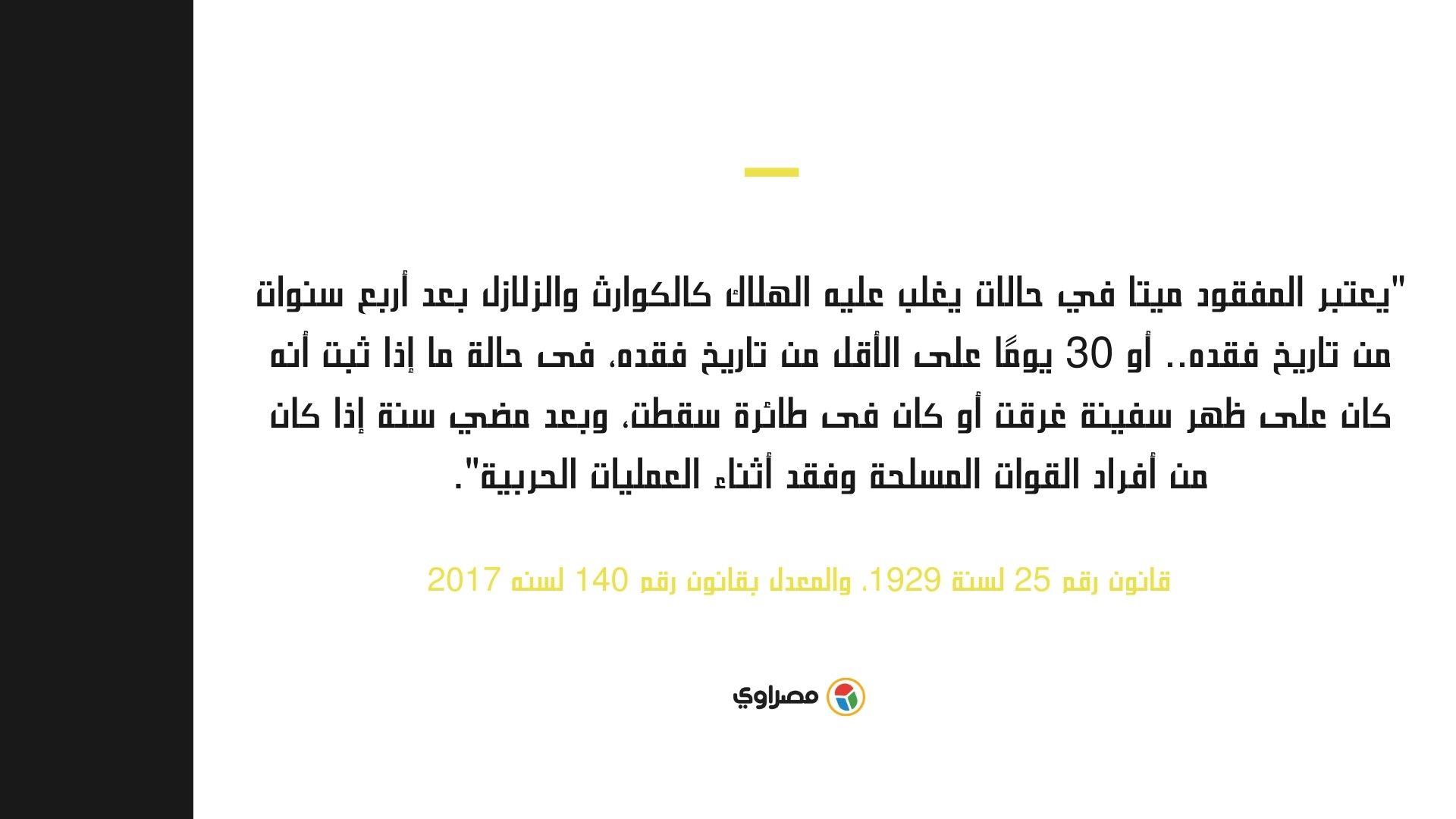
اقرأ أيضًا: من “الأحواش” إلى البحر.. قرية مصرية “غرقت” في إعصار ليبيا

